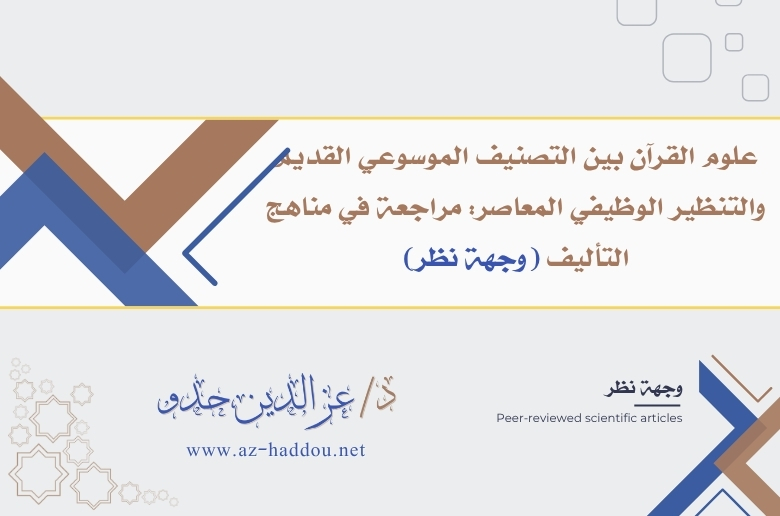علوم القرآن بين التصنيف الموسوعي القديم والتنظير الوظيفي المعاصر: مراجعة في مناهج التأليف (وجهة نظر)
علوم القرآن بين التصنيف الموسوعي القديم والتنظير الوظيفي المعاصر
ظلَّت علوم القرآن -عبر التاريخ- أحد الحقول المعرفية التي زخرت بتأليفات العلماء واجتهاداتهم، حيث اجتهد الأوائل في جمع مباحثها، وتأصيل مسائلها، وصياغة تصانيفها، مستهدفين حفظ النص القرآني وفهمه واستنباط هداياته. ولئن كان ذلك النتاج محلّ اعتزاز واعتراف، فإن النظر النقدي في مناهج التأليف التي سادت في القرون الأولى، وما طرأ عليها من تحولات في التأليف المعاصر، يكشف عن إشكالات منهجية ومعرفية تستدعي وقفة مراجعة وتأمل.
إنّ المتأمل في مناهج التأليف القديمة في علوم القرآن يلحظ سمة التجميع الموسوعي، حيث كان المؤلفون يميلون إلى استقصاء المباحث، وتضمين كل ما يتصل بالقرآن من علوم، دون ترتيب دقيق للمقاصد أو تفكيك لوظائف العلوم. فكان كتاب “الإتقان في علوم القرآن” للسيوطي، على عظم شأنه، نموذجًا بارزًا لهذا المنهج؛ إذ جمع فيه المؤلف ما يزيد عن ثمانين نوعًا من علوم القرآن، معتمدًا ترتيبًا موضوعيًا ظاهريًا، دون أن يربط المباحث بوظائفها الكبرى في فهم النص أو صيانته أو تنزيله.
وفي تقديري، فإن هذا المنهج -وإن كان مبرَّرًا في سياق خدمة النص القرآني في زمن لم تتبلور فيه التصنيفات الدقيقة- إلا أنه أحدث تراكماً معرفيًا غير منظم مقاصديًا، إذ اختلط فيه ما هو تأسيسي بما هو خادم، وما هو قطعي بما هو اجتهادي، وما هو نصي بما هو تاريخي. وقد انعكست هذه البنية على أجيال من طلاب علوم القرآن، فتلقَّوا هذه العلوم بوصفها معارف متفرقة، لا كمنظومة معرفية مترابطة تسعى إلى غاية تربوية وفكرية محددة.
أما التأليف المعاصر في علوم القرآن، فقد جاء في سياق معرفي ومنهجي مغاير؛ إذ شهد الفكر الإسلامي تحولات بنيوية فرضتها تطورات العلوم الإنسانية، وتجليات الخطاب الحداثي، والتحديات التي واجهها المسلمون في قضايا النص وتأويله. فظهرت محاولات لتحديث مناهج التأليف، بعضها سعى إلى إعادة تصنيف المباحث وفق مناهج أكاديمية (كما فعل الزرقاني في “مناهل العرفان”)، وبعضها الآخر استهدف مقاربة قضايا بعينها بمنهج تحليلي نقدي، متأثّرًا بمناهج العلوم الاجتماعية واللسانية.
غير أني أرى — وبدافع علمي صريح — أن معظم هذه المحاولات بقيت أسيرة إعادة إنتاج النسق الموسوعي القديم، أو الاستسلام لهيمنة المناهج الوضعية الحديثة دون بناء نموذج تأليفي أصيل يستند إلى مقاصد النص القرآني ووظائفه التربوية والاجتماعية. إذ نادرًا ما نجد تأليفًا معاصرًا يعيد ترتيب مباحث علوم القرآن وفق علاقتها بوظائفها الكبرى:
-
حفظ النص (كرسم المصحف، القراءات، الجمع).
-
فهم النص (كأسباب النزول، المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ).
-
تنزيل النص (كالتفسير وقواعد الاستنباط).
-
استثمار النص تربويًا واجتماعيًا (كالمقاصد، القيم، والآداب).
وأحسب أن هذا الخلل المنهجي في مناهج التأليف الحديثة نابع من غياب تقعيد نظري منهجي لمفهوم “علوم القرآن” ذاته، وعدم تحديد العلاقة الوظيفية بين مباحثه المختلفة. فظلّت بعض المؤلفات حبيسة العرض التاريخي أو الترتيب التقليدي، دون بناء نسق معرفي يربط العلم بمقاصده وأثره في الواقع.
لهذا، فإنني أميل إلى الدعوة لتأسيس منهج تأليفي مقاصدي وظيفي في علوم القرآن، يقوم على المبادئ الآتية:
-
تصنيف مباحث علوم القرآن حسب وظيفتها في خدمة النص: حفظًا، وفهمًا، وتنزيلاً.
-
تحرير العلاقة بين علوم القرآن والعلوم الاجتماعية واللسانية، بما يخدم فهم النص دون استلاب منهجي.
-
نقد الموروث التأليفي لا بنيةً معرفيةً فقط، بل في منطلقاته وأهدافه ومدى ملاءمته لقضايا الإنسان المعاصر.
-
إعادة بناء علوم القرآن في ضوء مقاصد الشريعة، لا باعتبارها علومًا معرفية فقط، بل وسائل تربوية لبناء الإنسان المؤمن الفاعل.
إن علوم القرآن ليست معارف تاريخية، ولا مجرد مباحث نصية جامدة؛ بل هي — في أصل نشأتها — علومٌ وظيفتها حفظ الرسالة وفهمها وتنزيلها. وكل تأليف لا يستحضر هذه الوظيفة يظل قاصرًا مهما بلغت فخامته العلمية.
وفي الختام، أؤكد أن تجديد مناهج التأليف في علوم القرآن ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة ملحّة تمليها طبيعة التحولات المعرفية والقيمية التي تعصف بالأمة اليوم. وواجبنا العلمي أن ننقل علوم القرآن من فضاء التكديس الموسوعي إلى فضاء الفعل التربوي والاجتماعي، عبر منهج تأليفي يتأسس على المقاصد القرآنية الكبرى، ويستحضر السياق الحضاري والإنساني المعاصر.